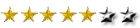هناك صنف من البشر اعتاد وأدمن
الشكوى والبكاء والشعور بالرثاء لحاله. بل أدمن الحزن والأسى
حتى أصبح الحزن نفسه.
وتجد هؤلاء يشكون من كل شيء وأي شيء، ويشعرون أن لديهم
مشاكل وهموما تفوق طاقة تحمّلهم. ولا ينفكّون يقصّون عليك
قصصهم المليئة بالأحزان و خيبات الأمل والصدمات التي مرّوا بها
في رحلة حياتهم. فتجد نفسك متأثرا بقصصهم متحمّسا لإيجاد
الحلول لهم ولكن ما أن تقترح لهم حلا أو تصف لهم علاجا
لمشكلة ما من مشاكلهم العديدة ـ حسب تعبيرهم ـ إلا وتجدهم ينشدون لك
أغنيتهم المفضّلة : ( طريقك يا ولدي مسدود مسدود ) وإذا ما فكّرت لهم
بمخارج ووهبتهم عصارة تفكيرك ونصحتهم بنصيحة يرى العقل
والمنطق جدواها ولو بنسبة ضئيلة نعتوك بأنك رومانسي الرؤى
خيالي الأفكار أو اتهموك بأنك لم تفهم بعد حقيقة الوضع المأساوي
الذي يعيشون، والذي يضطرهم أن يسلّموا ويستسلموا مفضّلين في
الواقع دور الضحية الذي تقمّصوه حتى قتل بداخلهم كل أمل أو رغبة أو إرادة.
فهم يرون الخيبة تتربّص بهم في نهاية كل مطاف، وأن الحزن والبؤس
نصيبهم وقسمتهم في الحياة. وفكرة أن الحظ مجانبهم تسيطر على
تفكيرهم فيعيشون هذا الوهم وينسجون خيوطه حولهم وحول حياتهم
حتى يخنقهم وهم منغمسون في الحسرة والحزن. ويصبح الأمل خيالا
يتراقص في المقلة ولا يتعداها ولا ينغرس فيها ليصل إلى القلب.
و دائما يجدون ما يبرّرون به مواقفهم السلبية تجاه الأحداث والظروف
والأشخاص.
وقد صدق قول الشاعر:
إنّما الميّت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
وقد يجد هؤلاء المأساويون تفهّم الأشخاص المحيطين بهم الذين
لا بد سيتعاطفون معهم، ولكن مع مرور الوقت تصبح صحبتهم حملا ثقيلا
وعبئا لا يحتمل. مما يدفع الآخرون إلى الابتعاد عنهم وتجنّبهم. لكن مع
الأسف لا يستطيعون فهم حقيقة ابتعاد الناس الذي ما جاء إلا نتيجة
حتمية لكثرة شكواهم ورفضهم سماع أي نصح بل وتحويل كل نصيحة وحلّ
إلى الطريق المسدود !!. وكأن مشكلتهم خُلقت من عسر وستبقى في
عسر حتى يرث الله الأرض وما عليها وإذا ما جرى أي تغيير في مشاكلهم
فهو تغيير
إلى مزيد من العسر والسوء ـ ولا حول ولا قوّة إلا بالله ـ وهذا قول لا يقبله عقل
ولا يستسيغه منطق. فقد تتكالب المصائب على المرء وقد تنهال المشاكل
على رأسه كالمطارق، وقد تحاصره الأزمات وتضيّق عليه حتى يشعر بالاختناق..
وقد يطول ليل الهمّ .. لكن لابد لكل ليل من نهار مهما طال ولا بد من انفراج
بعد كل عسر.
وهذا ما تجد نفسك تريد إيصاله لهؤلاء الذين يردّدون ترانيم البؤس .. لأن الله
في كتابه وعد بأن يكون مع العسر يسر بل يسران.
وما من شدّة إلا سيأتي لها، من بعد شدّتها رخاء.
وما يصيبك بالدهشة والذهول من أمر هؤلاء المدمنين للشكوى أنهم يؤكّدون لك
أنهم يفوّضون أمرهم لله ويحتسبون همّهم لديه، ويدعونه ليل نهار ويسبّحونه
آناء الليل وأطراف النهار. فتجد نفسك أسير مزيد من الحيرة إذ أغلقوا أمامك
بابا جديدا
تنصحهم من خلاله باللجوء إلى الله. فهم يفعلون لكنهم في الواقع لا يؤمنون
بجدوى ذلك. وكأنهم يفعلون ذلك من منطلق ( رفع العتب ) أو لمزيد من الانغماس
في الدور الذي رسموه لأنفسهم.
فلا تجد أمامك غير أن تضرب كفا بفك وتقول : لا حول ولا قوّة إلا بالله.
وتلوذ بالفرار من هلاك محقّق لأعصابك إن أنت أطلت صحبة هؤلاء أو استمعت
لمزيد من شكواهم.
فهم أناس أدمنوا الحزن وأصبح ذلك يشكّل لذّة لهم. واللذّة تنبع من إحساسهم
بأن الآخرين هم السبب فيما يعانون. وأنهم أبرياء غير مسؤولين عن الوضع الذي
يعيشونه. مما يجعلهم لا يشعرون شعور الإنسان الذي لا بد أن ينقذ نفسه،
ويضع له هدفا ليرقى بوضعه. فيبقى ( محلّك سرّ ) ويبقى يمارس دور الضحية
الذي عشقه والذي يطلق عليه دور ( المسالم ) في حين أنه دور ( المستسلم ) الذي
امتلأت حياته بالأوهام والفشل والسلبية وماتت لديه الإرادة وانتحر الأمل.
بل وفقد معاني إيمانية كثيرة يمارسها طقوسا في صلاة وتسابيح لكنه
لا يعيشها بقلبه وعقله ويقينه وقناعاته وإيمانه.
وما فائدة الصلاة والدعاء والاستغفار إن لم يؤمن المرء حقا بجدواها بأن ينغرس
بداخله الأمل والثقة بأن الله قادر على أن يغيّر من حال إلى حال أفضل؟.
ما فائدة عبارات التوكّل والاحتساب وتفويض الأمر لله إن لم يكن صاحبها
مؤمنا حقا بأن الله حسبه وكافيه وبصير بحاله؟؟
عجبت لمعشر صلّوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابا
يظن البعض أن التغيير ضربة حظ أو معجزة ينعم الله بها على من يختار
وينسون أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.
وأقول لهؤلاء الذين استعذبوا دور الضحية ـ على اختلاف أنماطه وظروفه ـ
وأدمنوا الشكوى والبكاء ورفضوا إلا أن يكون طريقهم مسدودا مسدودا :
هناك أوقات يكون فيها أعظم تغيير يجب إجراؤه هو تغيير وجهة نظرنا
تجاه الأمور إن لم نستطع تغيير أنفسنا في مواجهتها.
فالحكمة تقتضي أنه إذا لم يعجبك شيء فغيّره فإذا لم تستطع تغييره
فغيّر موقفك تجاهه ولكن ..... لا تشكُ.
الشكوى والبكاء والشعور بالرثاء لحاله. بل أدمن الحزن والأسى
حتى أصبح الحزن نفسه.
وتجد هؤلاء يشكون من كل شيء وأي شيء، ويشعرون أن لديهم
مشاكل وهموما تفوق طاقة تحمّلهم. ولا ينفكّون يقصّون عليك
قصصهم المليئة بالأحزان و خيبات الأمل والصدمات التي مرّوا بها
في رحلة حياتهم. فتجد نفسك متأثرا بقصصهم متحمّسا لإيجاد
الحلول لهم ولكن ما أن تقترح لهم حلا أو تصف لهم علاجا
لمشكلة ما من مشاكلهم العديدة ـ حسب تعبيرهم ـ إلا وتجدهم ينشدون لك
أغنيتهم المفضّلة : ( طريقك يا ولدي مسدود مسدود ) وإذا ما فكّرت لهم
بمخارج ووهبتهم عصارة تفكيرك ونصحتهم بنصيحة يرى العقل
والمنطق جدواها ولو بنسبة ضئيلة نعتوك بأنك رومانسي الرؤى
خيالي الأفكار أو اتهموك بأنك لم تفهم بعد حقيقة الوضع المأساوي
الذي يعيشون، والذي يضطرهم أن يسلّموا ويستسلموا مفضّلين في
الواقع دور الضحية الذي تقمّصوه حتى قتل بداخلهم كل أمل أو رغبة أو إرادة.
فهم يرون الخيبة تتربّص بهم في نهاية كل مطاف، وأن الحزن والبؤس
نصيبهم وقسمتهم في الحياة. وفكرة أن الحظ مجانبهم تسيطر على
تفكيرهم فيعيشون هذا الوهم وينسجون خيوطه حولهم وحول حياتهم
حتى يخنقهم وهم منغمسون في الحسرة والحزن. ويصبح الأمل خيالا
يتراقص في المقلة ولا يتعداها ولا ينغرس فيها ليصل إلى القلب.
و دائما يجدون ما يبرّرون به مواقفهم السلبية تجاه الأحداث والظروف
والأشخاص.
وقد صدق قول الشاعر:
إنّما الميّت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
وقد يجد هؤلاء المأساويون تفهّم الأشخاص المحيطين بهم الذين
لا بد سيتعاطفون معهم، ولكن مع مرور الوقت تصبح صحبتهم حملا ثقيلا
وعبئا لا يحتمل. مما يدفع الآخرون إلى الابتعاد عنهم وتجنّبهم. لكن مع
الأسف لا يستطيعون فهم حقيقة ابتعاد الناس الذي ما جاء إلا نتيجة
حتمية لكثرة شكواهم ورفضهم سماع أي نصح بل وتحويل كل نصيحة وحلّ
إلى الطريق المسدود !!. وكأن مشكلتهم خُلقت من عسر وستبقى في
عسر حتى يرث الله الأرض وما عليها وإذا ما جرى أي تغيير في مشاكلهم
فهو تغيير
إلى مزيد من العسر والسوء ـ ولا حول ولا قوّة إلا بالله ـ وهذا قول لا يقبله عقل
ولا يستسيغه منطق. فقد تتكالب المصائب على المرء وقد تنهال المشاكل
على رأسه كالمطارق، وقد تحاصره الأزمات وتضيّق عليه حتى يشعر بالاختناق..
وقد يطول ليل الهمّ .. لكن لابد لكل ليل من نهار مهما طال ولا بد من انفراج
بعد كل عسر.
وهذا ما تجد نفسك تريد إيصاله لهؤلاء الذين يردّدون ترانيم البؤس .. لأن الله
في كتابه وعد بأن يكون مع العسر يسر بل يسران.
وما من شدّة إلا سيأتي لها، من بعد شدّتها رخاء.
وما يصيبك بالدهشة والذهول من أمر هؤلاء المدمنين للشكوى أنهم يؤكّدون لك
أنهم يفوّضون أمرهم لله ويحتسبون همّهم لديه، ويدعونه ليل نهار ويسبّحونه
آناء الليل وأطراف النهار. فتجد نفسك أسير مزيد من الحيرة إذ أغلقوا أمامك
بابا جديدا
تنصحهم من خلاله باللجوء إلى الله. فهم يفعلون لكنهم في الواقع لا يؤمنون
بجدوى ذلك. وكأنهم يفعلون ذلك من منطلق ( رفع العتب ) أو لمزيد من الانغماس
في الدور الذي رسموه لأنفسهم.
فلا تجد أمامك غير أن تضرب كفا بفك وتقول : لا حول ولا قوّة إلا بالله.
وتلوذ بالفرار من هلاك محقّق لأعصابك إن أنت أطلت صحبة هؤلاء أو استمعت
لمزيد من شكواهم.
فهم أناس أدمنوا الحزن وأصبح ذلك يشكّل لذّة لهم. واللذّة تنبع من إحساسهم
بأن الآخرين هم السبب فيما يعانون. وأنهم أبرياء غير مسؤولين عن الوضع الذي
يعيشونه. مما يجعلهم لا يشعرون شعور الإنسان الذي لا بد أن ينقذ نفسه،
ويضع له هدفا ليرقى بوضعه. فيبقى ( محلّك سرّ ) ويبقى يمارس دور الضحية
الذي عشقه والذي يطلق عليه دور ( المسالم ) في حين أنه دور ( المستسلم ) الذي
امتلأت حياته بالأوهام والفشل والسلبية وماتت لديه الإرادة وانتحر الأمل.
بل وفقد معاني إيمانية كثيرة يمارسها طقوسا في صلاة وتسابيح لكنه
لا يعيشها بقلبه وعقله ويقينه وقناعاته وإيمانه.
وما فائدة الصلاة والدعاء والاستغفار إن لم يؤمن المرء حقا بجدواها بأن ينغرس
بداخله الأمل والثقة بأن الله قادر على أن يغيّر من حال إلى حال أفضل؟.
ما فائدة عبارات التوكّل والاحتساب وتفويض الأمر لله إن لم يكن صاحبها
مؤمنا حقا بأن الله حسبه وكافيه وبصير بحاله؟؟
عجبت لمعشر صلّوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابا
يظن البعض أن التغيير ضربة حظ أو معجزة ينعم الله بها على من يختار
وينسون أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.
وأقول لهؤلاء الذين استعذبوا دور الضحية ـ على اختلاف أنماطه وظروفه ـ
وأدمنوا الشكوى والبكاء ورفضوا إلا أن يكون طريقهم مسدودا مسدودا :
هناك أوقات يكون فيها أعظم تغيير يجب إجراؤه هو تغيير وجهة نظرنا
تجاه الأمور إن لم نستطع تغيير أنفسنا في مواجهتها.
فالحكمة تقتضي أنه إذا لم يعجبك شيء فغيّره فإذا لم تستطع تغييره
فغيّر موقفك تجاهه ولكن ..... لا تشكُ.